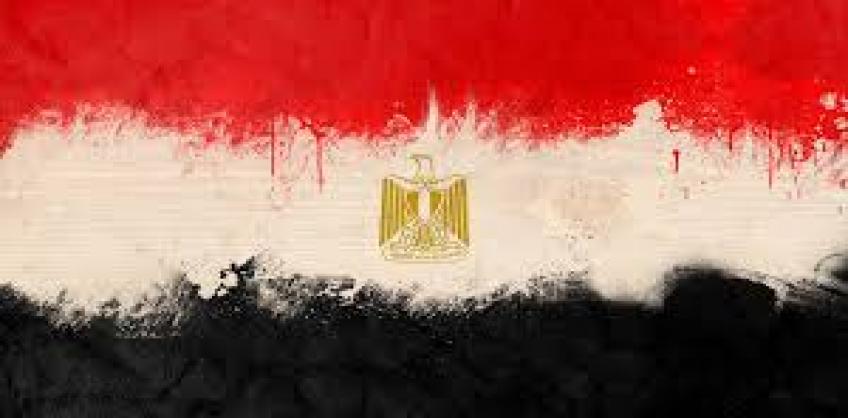مصر: البحث عن الاستقرار
جون ألترمان&ويليام مكانتس
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)
عندما تمّ تدمير مُتحف الفن الإسلامي في القاهرة عن طريق انفجار سيارة ملغومة في يناير / كانون الثاني عام 2014م، كشف الهجوم عن وجهٍ جديدٍلمشكلة قديمة في مصر. وكافح حكام البلاد– سواءً القوى الأوروبية الاستعمارية أوالإدارات الخديوية العثمانيةأو المصريين أنفسهم - ضد ما ينظرون إليه على أنهتطرف ديني على مدى أكثر من قرنين من الزمان. ويقع المتحف عبر شارع مليء بالمنشئآت الأمنية كانتهي الهدف الأساسي من وراء الهجوم. ووسط الركام والأنقاض التي حوت قناديل المساجد المحطمة التي تعود للعصور الوسطى ومحاريب الصلاة القديمة التي تعود لألف عام كان هناك دلالات قوية على أنه لا حماية لشيء أو أحدٍ في هذا الاضطراب والصراع العنيف. وسارعت الحكومة باتهام جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الذي سارعت فيه أيضًا مجموعة سلفية متشددة في سيناء - أنصار بيت المقدس–بإعلان مسئوليتها عن الهجوم. وأخذ كل جانب – جماعة الإخوان والحكومة - الهجوم ورد الفعل تجاهه كدليل على التطرف الكامن في معارضيه. واختار كل فريق الانغماس في الحرب بكل ما أوتي من قوة بحثًا عن البقاء.
ثبات التطرف في مصر هو اللغز؛ فمنذ سقوط الرئيس حسني مبارك في فبراير 2011م تمّ تفسيره على نطاق واسع على أنه نهاية متوقعة لصراعات عنيفة في المنطقة. وخاضت الحكومة المصرية حربًا ضد انتفاضة جهادية معظم فترة التسعينيات من القرن الماضي، والمصريون دائمًا يشكلون الكثير من العضلات وراء تنظيم القاعدة الدولي. وبرر الجهاديون العنف بأن هذا هو المسار الوحيد للتغيير في الوقت الذي لا تقبل فيه الحكومات العربية أي حل وسط مع خصومهم. وأظهر التحالف المتنوع الذي ساعد في الإطاحة بمبارك – العلمانيون والليبراليون وجماعة الإخوان المسلمين والشبابوأجزاء من مجتمع الأعمال –إمكانية ظهور نموذج جديد للحكم في مصر. وعندما استحوذ المرشحون السلفيون على أكثر من ربع المقاعد في أول برلمان في مصر بعد الثورة، فإن نجاحهم قدّم دليلاً لجميع الاطراف،فبالنسبة لليبراليين ظهر أن السلفيين كانوا على استعداد لتقاسم السلطة، وبالنسبة للسلفيين ظهر أنه يمكنهم كسب السلطة من قبل المشاركة في الانتخابات. معظم المقدمات الأساسية للحجة الجهادية تمّ انتزاعها.
وفي نهاية المطاف تلاشت آفاق نموذج جديد للحكم، وتصاعد العنف. وتسعى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخبة حديثًا لإعادة فرض النظام في مصر. ويسعى المسلحون السابقون والجماعات الإسلامية ذات الميول الأخرى لوضع أنفسهم وجهًا لوجه مع الحكومة الجديدة. وفي الوقت الذي تأمل فيه الحكومة المصرية تهدئة الاوضاع في البلاد كما فعلت حكومة مبارك في التسعينيات، فإن الكثير من المشككين يحذرون من أن الأساليب القسرية التقليدية من غير المرجح أن تُثبت فعاليتها في أعقاب الانتفاضات العربية كما حدث قبل عقدين من الزمن، وفي البيئة الإقليمية الحالية قد تجعل تلك الأساليب الأمور أكثر سوءًا.
التيار الإسلامي والراديكالية في مصر
لا يوجد إجماع في مصر حول السبب وراء تشكيل مجموعة راديكالية في البيئة الحالية. وتعجّ سجون مصر بالعلمانيين والدينيين على حد سواء، وعلاقة الجماعات الدينية بأولائك الذين يرتكبون أعمال عنف في مختلف المدن في مصر أمر متنازع عليه. وفي نواح كثيرة؛ تواجه مصر مشكلتيتطرف مختلفتين، على الرغم من أن البعض يراهما مجرد وجهين لعملة واحدة. جماعة الإخوان المسلمين – حركة وطنية تنتشر في كل ربوع مصر منذ قرابة قرن من الزمان - تنظر إليها الحكومة على أنها تهديد لها. وتتمثل المشكلة الثانية في تهديد جماعات رفعت راية العنف مثل جماعة أنصار بيت المقدس. وعلى الرغم من تركز الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، إلا أن عملياتها طالت أهدافًا حكومية ليس فقط في سيناء، لكنها أيضًا ضد أهدافًا في منطقة وادي النيل البعيدة عن شبه جزيرة سيناء.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في محافظة الإسماعيلية عام 1928مبمجموعة قومية من الشباب الذين انخرطوا في الخدمات الاجتماعية والدينية وتنمية الذاتوشنّوا هجمات ضد جنود الاحتلال البريطاني. ونتيجة لعملية القمع التي تعرضت لها جماعة الإخوان في عام 1948مقامت الجماعة باغتيال رئيس الوزراء محمود باشاالنقراشي الذي تصدى للجماعة التي اعتبرها تسعى للسلطة في مصر المضطربة بعد الحرب العالمية الثانية. وكان العديد من الضباط العسكريين الذين استولوا على السلطة في عام 1952م (بما فيهم جمال عبد الناصر وأنور السادات الذين صاروا رؤساء مصر في المستقبل) محسوبين على الإخوان المسلمين، كما تردد أن الضباط الأحرار عرضوا على الجماعة مناصب في حكومة ما بعد الملكية،ولكن مُرشد الإخوان المسلمين آنذاك حسن الهضيبيرفض العرضبحجة أن الإخوان لا ينبغي لهم أن يكونوا في السلطة حتى تتم أسلمة المجتمع تمامًا. وتنازع ناصر والهضيبي مرارًا وتكرارًا، وفي كل مرة يتعاركا ثم يصطلحا حتى حاول عضو في الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين اغتيال جمال عبد الناصر في أكتوبر 1954م. وفي أعقاب ذلك؛ اعتقلت الحكومة الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان وحكمت بالإعدام على عدد منهم ونُفّذ الحكم ضد بعضهم. وفي داخل سجون عبد الناصرانتهج أعضاء من جماعة الإخوان مثل سيد قطب منهجًا أكثر تطرفًا، وطوروا الأسس العقائدية للجهادية السلفية.
ويعود تاريخ ظهور السلفية في مصر إلى العشرينيات من القرن الماضي، فقد ظهرت جنبًا إلى جنب مع إعلان نشأة جماعة الإخوان المسلمين. وكرّست جهودها لتجريد الإسلام من التراكمات الثقافية وإعادة اكتشاف هدي النبي محمد، ونأت السلفية بنفسها عن ما يمت للسياسة بصلة ما جعل المشتغلين بالسياسة يأمنون جانب أتباعها. علاوة على ذلك؛ فقد رأى أتباع السلفية أن السياسة الحزبية قسمت المجتمع المسلم، ووصفوا البرلمانات بالهيئات غير الشرعية التي اغتصبت دور الله باعتباره المُشرّع الوحيد. ونظرًا لذلك؛ فقد سُمح للجماعات السلفية أن تنشأ دون مضايقات وتقوم بأعمالها وأنشطتها على مدى عقود من الزمن، كما كان هناك سبب آخر استدعى فتح المجال أمامها؛ ألا وهو معارضتهم ذات الطابع الإسلامي لجماعة الإخوان المسلمينالتي دخلت إلى السياسة بشكل صريح.
وبعد وفاة عبد الناصر في عام 1970م، سعى الرئيس أنور السادات لإعادة تأهيل الإخوان واستخدامهم كأداة لمواجهة الخصوم السياسيين الأخرى. ونظرًا لمواجهته معارضة شديدة بسبب جهوده لتفكيك الاشتراكية العربية وتمكين الطبقة الرأسمالية الجديدة، كان من بين حلول السادات إطلاق سراح العديد من أعضاء الإخوان المسلمين من السجن والسماحلهم بالعمل علانية. لكن سرعان ما توترت العلاقة بين الإسلاميين والسادات بعد أن بدأ السادات مبادرات الدبلوماسية العلنية مع إسرائيل. وعلى الرغم من خيبة أملها في السادات واستمرار تحرش حكومة السادات بها، إلا إن الجماعة حافظت على تعهدها بعدم اللجوء للعنف. ورغم ذلك؛ بدأت بعض المجموعات السلفية في مصر تنظم أنفسها لقلب نظام الحكم من منتصف وحتى نهاية السبعينيات، على رأس هذه المجموعات كانت حركة الجهاد الإسلامي المصرية (أو الجهاد) والتي كان مسئولة عن اغتيال الرئيس أنور السادات.
واستمر هذا التحول إلى العنف من قبل بعض الجماعات السلفية خلال فترة الثمانينيات. وبدأ العنف – السواد الأعظم منه بين المسجونين تحت حكم عبد الناصر والسادات على حد سواء –يزداد وجذب مشاركة المصريين في الجهاد الأفغاني وتشكيل ما أصبح لاحقًا يُعرف باسم تنظيم القاعدة. ودمجت العقيدة الجهادية العالمية لتنظيم القاعدة بين عناصر السلفية المصرية والسعودية، مُستلهمة من أفكار سيد قطب إسقاط الحكام المسلمين المرتدين ومن السلفية السعودية وجهة النظر الدينية الأكثر تحفظًا. وكان أيمن الظواهري– أحد المقربين من أسامة بن لادن وتولى قيادة التنظيم العالمي بعد مقتل بن لادن– مُولعًا بسيد قطب. وتحت قيادة الظواهري في أواخر الثمانينيات، أعطت عودة المحاربين القدامى من الجهاد الأفغاني المبرر وكذلك العضلات لحركة متشددة عنيفة تستهدف الحكومة المصرية. واستطاعت الحكومة المصرية بنجاح احتواء التهديد الجهادي العنيف تارة من خلال القمع وتارة من خلال الاستقطاب.
خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات؛ شنّ خليفة السادات – حسني مبارك - حملة وحشية ضد الجماعة الإسلامية؛ وهي المجموعة التي حملت أفكار التشدد التي دعا إليها سيد قطب، وقامت بإنشاء جناح مُسلح، وهاجمت المسيحيين، ووصلت إلى حد سيطرتها على حي مجاور للقاهرة. واعتقلت أجهزة الأمن المصرية عشرات الآلاف من المسلحين والمتشددين المشتبه بهم ونُشرت قوات مسلحة على نطاق واسع في صعيد مصر؛ حيث كان تنتشر قاعدة دعمها الأقوى. ولم يكن رد فعل الحكومة محصورًا في البندقية. وفي محاولة لتوفير فرص عمل وبنية تحتية للسكان الذين شعروا باحتياجهم لهذين الأمرين، وجهت حكومة مبارك الملايين من الجنيهات لتوفير الموارد لصعيد مصر. وكان المحطة الثالثة من استراتيجية الحكومة أيديولوجية؛ حيث سعت لإقناع المسلحين بالأخطاء العقائدية في تفكيرهم. وفي فترة التسعينيات انتزعت الحكومة من أعضاء المجموعة اعترافات بالتراجع عن أفكارهم، وذلك راجع في جزء منه إلى جهد واسع النطاق من قبل علماء الدين التقليديين، وربما ساعده العداء الشخصي الذي يشعر به بعض قادة الجماعة تجاه أيمن الظواهري نائب تنظيم القاعدة. وفي الوقت الذي هدأ فيه الغبار، فإن معظم أعضاء الجماعة تخلوا عن العنف واعترفوا بسلطة الدولة. كما دفع موقف الحكومة المتشدد فصيل جهادي رئيسي – جماعة الجهاد المسئولة عن اغتيال السادات - إلى التخلي عن حملتها ضد الحكومة. وطوال هذه الفترة؛ سُمح للجماعات السلفية التي اعترفت بسلطة الدولة ونبذت العنف (مثل الدعوة السلفية في الإسكندرية) بالاستمرار في نشاطهاالدعوي، على الرغم من أنها عانت في بعض الأحيان المضايقات على مستوى منخفض من قبل السلطات.
وتميز أسلوب حسني مبارك بالتناوب بين السماح لجماعة الإخوان المسلمين تارة والقمع تارة أخرى. وفي مقابل الإفراج عن أعضائها من السجن، أيدت الجماعة مبارك في رئاسته عام 1988م، كما سمح للإخوان بإنشاء المستشفيات والمدارس والسيطرة على العديد من النقابات المهنية في البلاد. وكان الإخوان أيضًا أقلية صغيرة في البرلمان لكن صوتهم كان يُسمع كثيرًا، وكان هؤلاء الأعضاء لا يعملون تحت مظلة جماعة الإخوان المسلمين - والتي لم تكن منظمة معترف بها ولا حتى حزب سياسي قانوني–ولكنهم عملوا من خلال التحالف مع أحزاب أخرى أو كأعضاء مستقلين. فشل جماعة الإخوان المستمرفي الحصول على الوضع القانوني سمحللحكومة بتغيير الطرق التي تنتهجها ضد جماعة الإخوان، وأيضًا عندما تريد إلقاء القبض على أعضاء جماعة الإخوان ومصادرة أصولها. ومن الناحية العملية؛ فإن الحكومة نجحت في إدارة المنظمة من خلال التناوب بين الاستقطاب والإكراه. وبالنسبة للكثيرين في مصر والكثير من المستويات العليا في الحكومة الأمريكية وأجهزة الاستخبارات فإن الاستراتيجية لم تكن تعمل بشكل كاف فحسب، ولكنها أيضًا عززت قرارات الإخوان بالتخلي عن ماضيها العنيف.
بعد الانتفاضة
بعد سقوط مبارك؛رأى خلفائه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن بقائهم يعتمد على استرضاء العنصر الأكثر تنظيماً في المعارضة؛ ألا وهو "الإسلاميين". ونتيجة لذلك؛ فقد اتبعوا نفس الاستراتيجية التي اعتمد عليها مبارك والسادات؛ حيث أمر المجلس العسكري بالافراج عن عدد من السجناء الإسلاميين البارزين "مثل قادة الإخوان المسلمين؛ خيرت الشاطر وحسن مالك"، وكذلك بعض السلفيين الجهاديين. كما سمح المجلس العسكري بعودة العديد من الإسلاميين من المنفى، وسمح للإخوان والجماعات الإسلامية الأخرى بتشكيل أحزاب سياسية. وعلى غرار ما فعلت المؤسسة العسكرية، تعاونت وزارة الداخلية أيضًا مع الإخوان.
وفي الوقت الذي بدأفيه بعض السلفيين إعادة النظر في النشاط السياسي في عام 2000، فإن القاعدة الأساسيةللسلفيين لم تفكر في السياسة إلا بعد سقوط حسني مبارك. وقبل عام 2011؛ صنف السلفيون أنفسهم في كثير من الأحيان على أنهم البديل الإسلامي "النقي" لجماعة الإخوان المسلمين، والذين وصفوا بأنهم حاولوا الوصول إلى تسوية ميئوس منها بالمشاركة في انتخابات مزورة وبرلمان عاجز.
ولكن عندما واتى السلفيون فرصة خوض انتخابات حرة وأدركوا أن منافسيهم سيجنون ثمار السلطةبدأت المساومة على تأسيس دولة إسلامية وشرع السلفيون في تأسيس أحزاب سياسية. وأنشأت الدعوة السلفية حزب النور، وأسست الجماعة الجهادية السابقة "الجماعة الإسلامية" حزب البناء والتنمية، وقام إثنان من الشخصيات السلفية في القاهرة بتأسيس أحزاب صغيرة خاصة بهم.و شكلت الأحزاب تحالفًا هيمن عليه حزب النور للمنافسة ضد الإخوان، واستطاع الحصول على مايقرب من 24% من مقاعد البرلمان.
وعندما انُتخب محمد مرسي - مرشح الإخوان المسلمين - كرئيس في مايو 2012م، أظهرت الأجهزة العسكرية والأمنية تعاونًا في البداية. ولكن بعد إعلان مرسي الدستوري في 21 نوفمبر 2012؛ والذي فُسر على نطاق واسع بأنه استيلاء على السلطةتغير الوضع تمامًا. وقام مرسي بإقالة وزير الداخلية لعدم تضييق الخناق بما فيه الكفاية على المتظاهرين المحتجين على الإعلان الدستوري، وخلال فترة استبدال الوزير تم قمع المظاهرات بوحشية في بورسيعد الهادئة نسبيًا، ما أدى إلى تدخل الجيش لتهدئة الوضع. وخرج نطاق الاحتجاجات عن سيطرة مرسي، وكان ذلك مبرر وأساس منطقي لمزيد من التدخل العسكري. وكان مرسي بالفعل على خلاف مع وسائل الإعلام الخاصة والسلطة القضائية المؤيدة بقوة للنظام القديم. وعلى الرغم من أن حزب النور تعاون مع مرسي في صياغة الدستور، لكن العلاقة معه ومع الإخوان المسلمين بشكل عام كانت حادة. ورأى عدد من أعضاء حزب النور أن الإخوان المسلمين استغنوا عنهم، وقام الحزب بالاستغناء عن المؤسس الرئيسي له في يناير 2013م لكونه قريب جدًا من الإخوان المسلمين. وكانت الضربة القاتلة هي فقدان ثقة الجيش في قدرة مرسي على الحكمجنبًا إلى جنب مع فشله في تأسيس إئتلاف حاكم على نطاق واسع.
وتدخل الجيش بعد احتجاجات شعبية كبيرةفي 3 يوليو 2013م، ووضع مرسي والعديد من كبار مستشاريه تحت الإقامة الجبرية. وفي 24 يوليو؛ تكلم السيسي - كان لا يزال وقتها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - بلهجة حادة ضد جماعة الإخوان المسلمين. وفي كلمة ألقاها خلال عرض عسكري؛ اتهم الإخوان بتسليح أنفسهم ضد النظام، وطلب من الجمهور "تفويض" للسماح له "بمواجهة الإرهاب والعنف". وبعد استجابة الملايين لدعوتة للتظاهر تفويضًا له في 26 يوليوأمر السيسي الجيش والشرطة في 24 أغسطس بفض اثنين من أكثر الإعتصامات الجماهيرية المؤيدة لمرسي في القاهرة. وقتلت عناصر الشرطة والجيش مابين 600 إلى 2600 شخص من المدنيين. وفي سبتمبر 2013؛ صدر حكم قضائي بحظر جماعة الإخوان المسلمين، والذي كان له تأثير على تجميد أصول الجماعة وهدم بنيتها التحتية الإقتصادية. وفي ديسمبر 2013؛ تمّ إعلان التنظيم كجماعة إرهابية كوسيلة لتضييق الخناق بشكل أكثر "رداً على التفجير الذي حدث في دلتا النيل والذي أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسئوليتها عنه". ومنذ ذلك الحين؛ حكمت المحاكم المصرية على أكثر من ألف من أنصار الإخوان بالإعدام، وأكثر من 200 حكم من هذه الأحكام تم تأييدها؛ بما في ذلك ما صدر ضد المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع؛ والذي يواجه أيضًا عدة أحكام بالسجن مدى الحياة.
وانقسمت الحركة السلفية بعد الإطاحة بمحمد مرسي بشكل أكثر عمقًا. وفي الوقت الذي كانت فيه النهاية الواضحة لحكم الإسلاميين بمثابة تحذير للعديد من التيارات السلفية في مصر، فقد تحلت قيادة حزب النور بالصبر وتوخت الحذر. وكما أوضح أحد قيادات الحزب "إختيار أخف الضررين". والحقيقة هي أن هؤلاء الناس يؤيدون هذه الحكومة أو على الأقل يعطون السيسي شرعية كافية للمناورة، وهذه هي إرادة الشعب وإرادة الجيش. وأضاف نفس القيادي "تستطيع أن تحقق المكاسب إذا استطعت البقاء في النضال". بينما اتخذ المعارضون السلفيون لحزب النور على وجه التحديد الحجج المعاكسة. وجادل أحد القادة السلفيين البارزين أنه من خلال دعم الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب ديمقراطيًا، فإن حزب النور سيفقد مصداقيته على المدى الطويل كحزب معارض بشكل جاد.
وفي 2014م؛ جعل السيسي القضاء على الإخوان مفتاح رئيسي في محاولته الناجحة للوصول للرئاسة. وتعهد خلال مقابلة مع قناة مصرية في شهر مايوبالقضاء على جماعة الإخوان واجتتاث جذورها. وبمجرد أن تم انتخاب السيسي - بنسبة بلغت 97% - استمر في سياسته المتشددةرافضًا التصالح مع أولائك الذين ارتكبوا جرائم أو يتخذون العنف كمنهجية لتحقيق ما يسعون إليه. كما أكد أنه لن يكون هناك أي تعاون أو استرضاء لأولائك الذين يلجأون إلى العنف والذين يريدون عرقلة تحركنا نحو المستقبل. وحتى لو أراد السيسي التصالح مع جماعة الإخوان، فإن أنصاره سيُصعّبون هذه الخطوة عليه وربما يقفون له بالمرصاد. ومن بين هؤلاء الذين يريدون السيسي وقد ينقلبون عليه حال تصالح مع الإخوان الحكومات المحافظة في الخليج، والتي توفر مليارات الدولارات للحفاظ على الاقتصاد المصري واقفًا على قدميه في ظل الأزمات التي تتربص به منذ الإطاحة بمحمد مرسي. وترى هذه الحكومات الإخوان تهديدًا قاتلاًلهم ولحكمهم، وتنشط بشكل متزايد في الجهود الإقليمية الرامية إلى تقويض تنظيم الإخوان المسلمين.
وردًا على الهجمة الموجهة ضدها؛ رفضت جماعة الإخوان بشكل رسمي مرارًا وتكرارًا أي تأييد للعنف أو حتى تعاطف معه. ويؤكد أعضائها أن التنظيم ليس لديه جناح شبه عسكري، وأن قادتها لا يوافقون على الإطاحة العنيفة بالحكومة المصرية. وذكر وزير شاب بارز في حزب الحرية والعدالة في مارس 2014 أن " شباب الإخوان المسلمين ملتزمون بالسلمية المُبدعة في مناهضتهم للانقلاب، وأنهم لن يهاجموا أبدًا أي مصري بأي شكل من الأشكال". وفي مايو، أصدر محمد على بشر - عضو مجلس شورى جماعة الإخوان - بيانًا ندد فيه بالعنف ضد عناصر الجيش والشرطة. كما أكد المرشد العام للجماعة محمد بديع خلال ظهوره في المحكمة في يونيو أن "جماعة الإخوان المسلمون لا تعرف سبيلاً للعنف". وعندما تم تفجير مترو القاهرة؛ نفت جماعة الإخوان ما أعلنته الحكومة بتورط الإخوان فيه، وكررت "لن ننجر إلى العنف والدمار على الرغم من العنف المنهجي الذي تستخدمه سلطات الانقلاب منذ بداية الانقلاب وحتى يومنا هذا"،كما أكدتالجماعة أن الجاني الحقيقي هو النظام نفسه، والذي يسعى إلى تشويه سمعة الإخوان وإلصاق تهم العنف بها زورًا.
وعلى الرغم من هذه التأكيدات من قبل ممثلي الإخوان، ولكن يبدو أن أفراد الجماعة لا يتبعونها دائمًا وقد يُقدمون على تحركات فردية. وأدت المجزرة المرتكبة في حق أعضاء جماعة الإخوان إلى زيادة نزعة الاتجاه نحو العنف. وأدى القبض على قيادات التنظيم إلى لجوء أفراد الإخوان إلى أساليبهم الخاصة (ومن المعروف أن جماعة الإخوان عبارة عن تنظيم هرمي جدًا تعود على أخذ التعليمات من المستوى الأعلى نزولاً إلى المستوى الأدنى". وأدت أعمال العنف وفوضى الاعتقالات التي لم يسبق لها مثيل من قبل الحكومة إلى مشاركة أعضاء من الإخوان في عنف "محدود وصغير" - كما وصفه بعض المحللين - ضد المؤسسات الحكومية والأهداف المدنية وبعيدًا عن استهداف الأرواح. ويدّعي أنصار التنظيم أن العنف لا يزال يسير في إطار التعليمات التي حددتها قيادات الإخوان خلف القضبان بعدم استهداف الأشخاص.وفي منشور على صفحة إخوانية ذات شعبية بين المتظاهرين قبيل الذكرى السنوية لانقلاب 3 يوليودعا المسئول عنها "أنصار الشرعية لحمل أي شيء من شأنه أن يكون مفيدًا في الدفاع عن النفس وليس للقتل"، مُلمحًا إلى استخدام الحرائق لعرقلة حركة المترو من أجل إشعال اشتباكات واسعة مع عناصر الشرطة.
وبسبب القلق والخوف من فقدان الجماعة سيطرتها على عناصرها، يتسامح قادة الإخوان مع هذا النوع من الأعمال لإعطاء متنفس للأفراد الغاضبين ومنع الانشقاقات. ولكن لم يلتزم كل أفراد الجماعة بهذا النوع من العنف الصغير. حيث هدد البعض باغتيال مسئولين حكوميين. وأصدر أعضاء يطلقون على أنفسهم "حركة مولوتوف" بيانًا في 9 مارس مُهددين بقتل رجال شرطة في محافظة الأقصر جنوبي مصر. وهناك أيضًا شائعات عن أن أعضاء من جماعة الإخوان يقيمون معسكرات للتدريب العسكري في السودان وليبيا. وترى الحكومة من جانبهايدًاللإخوان تقريبًا في كل أعمال العنف المستمرة في البلاد، وتنسب للإخوان دعمها لأعمال العنف التي تحدث في سيناء بواسطة الجماعات السلفية الجهادية وأماكن أخرى.
التشدد في سيناء
وفي الواقع؛ فإن المشكلة الأمنية في سيناء لها خصوصيتها، ومشكلة التطرف التي تواجه الحكومة هناك صارخة للغاية؛ حيث إنها منطقة غير متطورة ومعزولة وتحت الاحتلال العسكري، كما أنها تُعتبر ملاذًا للمسلحين المناهضين للحكومة، وتشبه سيناء مناطق أخرى غير محكومة في العالم أكثر من كونها جزءًا داخل مصر. المظالم السياسية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة في القاهرة -بما في ذلك الإطاحة بمحمد مرسي- دفعت إلى التشدد في سيناء، ولكن هناك عوامل أخرى ذات أهمية أيضًا. ويعتبر شمال سيناء منذ فترة طويلة موطنًا للعديد من الجماعات المسلحة، وتكاثرت هذه الحركات وأصبحت أكثر جرأة في السنوات القليلة الماضية. أداء الحكومة المهتز والضعيف في القاهرة، بالإضافة إلى الإمدادات الثابتة التي تأتي من ليبيا والتي كانت إرثًا ونتيجةً لهذه الانتفاضات خلق حالة من الظروف المثالية لتوسع السلفية الجهادية في سيناء.
للبدو في سيناء تظلمات طويلة الأمد ضد الحكومة المصرية والجيش والأجهزة الأمنية مما ساهم في دفعهم نحو التشدد. واردرى سكان سيناء حكومة مبارك بشدة لإهمالها تنمية سيناء؛ وخاصة الأماكن التي هي بمعزل عن قليل من المناطق السياحية الشرقية. وينظر السكان المحليون أيضًا إلى أن المهاجرين من وادي النيل يتميزون عليهم في النواحي الاقتصادية والقانونية. وما يجعل الأمر أكثر سوءًا هو أن وزارة الداخلية تمارس باستمرار إجراءات مُكثفة في سيناء في الوقت الذي يركز فيه جهاز المخابرات العامة على جمع المعلومات بأي ثمن. وكانت النتيجة عنف مستشري وفسادوتصور عام أن الجهات الفاعلة الأكثر فسادًا في المنطقة تعمل محميّة بحصانة. وأجرت حكومة مبارك أيضًا حملات قاسية وعشوائية في بعض الأحيان على سكان البدو في أعقاب الهجمات الإرهابية في دهب وطابا وشرم الشيخ في منتصف العقد الماضي. وتركت هذه التجارب إرثًاضخمًا من العداء تجاه الحكومة المركزية في مصر والتي لم تستطع الحكومات التي جاءت بعد مبارك التغلب عليها.
ولا تُفسر تلك المظالم الموجهة ضد حكومة القاهرة وحدها انتشار المتشددين في سيناء منذ عام 2011م. فالجماعة السلفية الجهادية الأكثر فتكًا في سيناء المعروفة باسم أنصار بيت المقدس مُكونة إلى حد كبير من مصريين وفلسطينيين. وتم إنشاؤها في أعقاب انتفاضات عام 2011م، وقد أعلنت مسئوليتها عن موجة من الهجمات العنيفة رفيعة المستوى؛ معظمها في أعقاب الإطاحة بمرسي. وهناك بالإضافة إلى أنصار بيت المقدسمجموعات معروفة أو مشتبه بها في سيناء؛ وتشمل "شبكة محمد جمال" وتنظيم "القاعدة في شبه جزيرة سيناء" و"مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس" و"التوحيد" و"الجهاد"؛ وهذه الأخيرة تمّ اتهامها في تفجيرات طابا وشرم الشيخ ودهب 2004–2006م. واختلف المحللون في ربط الهجمات الأخيرة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو أنها كانت من بنات أفكار الجهاديين المرتبطيين بتنظيم القاعدة الذين جاءوا أصلاً من صعيد مصر؛ حيث كانت حكومة مبارك تحارب العنف الجهادي السلفي في فترة التسعينات من القرن الماضي.
ومازال من الصعب تحديد طبيعة انتماء هذه الجماعات من عدمه إلى تنظيم القاعدة الدولي. بعض هذه الجماعات؛ مثل تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناءأعلنوا ولائهم لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، والذي بدوره أشاد بأنشطة أنصار بيت المقدس. ويعارض الظواهري جماعة الإخوان المسلمين، وهذا الإقرار يرجح أن الهجمات التي تشنها جماعة أنصار بيت المقدس - والتي توسعت منذ يوليو 2013 - لم يكن يحركها الإخوان المسلمون. وادعى زعيم قبلي سيناوي في سبتمبر 2013م أن حوالي ألف من مقاتلي القاعدة - منهم ليبيين وفلسطينيين ويمنيين - كانوا يعملون في مناطق من سيناء. وفي نهاية 2014؛ تعهدت جماعة أنصار بيت المقدس بالولاء لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء" على الرغم من أن الروابط الفعلية بين الجماعتين لاتزال غير واضحة.
ويزداد الوضع في سيناء تعقيدًا بسبب العلاقة الغير مفهومة بين الجماعات السلفية الجهادية المحلية والإسلاميين الجهاديين في غزة المجاورة. ويتشارك سكان غزة في العديد من العلاقات مع البدو في شمال سيناء. ونسبت التفجريات التي حدثت في منتجعات سيناء في منتصف العقد الماضي إلى مسلحين لهم علاقة بالمنظمات الفلسطينية. وتعتبر سيناء في بعض الأحيان ملاذًا آمنًا للمسلحين في غزة، وتُعتبر أنفاق التهريب بين مصر وقطاع غزة منفذ اقتصادي مُهم للسكان على جانبي الحدود. وساهم تعاون نظام مبارك مع الحكومة الإسرائيلية في الحفاظ على الحصار المفروض على غزة في زيادة وجهة النظر المناهضة لمبارك في سيناء. وكان للجهود العدوانية لحكومة السيسي بإغلاق الأنفاق تأثير مماثل. مجموعة واحدة على الأقل في غزة هي "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس" والتي اعتادت مهاجمة أهداف إسرائيليةفي المقام الأول تهاجم أيضًا قوات الأمن المصرية بسبب تعاونها مع إسرائيل.
ونسبت الحكومة الحالية أعمال العنف في مصر إلى جماعة الإخوان المسلمين بدلاً من الجماعات الجهادية السلفية العاملة في البلاد. وبينما هناك ما يبرر توخي الحذر في تقييم هذه التهمة، فيبدو أن هناك القليل من الشك في أن القوات الجهادية السلفية التي تقاتل من سيناء تم تعزيز صفوفها بعدد غير معروف من السجناء الهاربين من السجن في أيام مبارك الأخيرة، بالإضافة إلى قرارات الحكومات المتعاقبة بالإفراج عن مئات السجناء الذين أمضوا عشرات السنين في السجون المصرية بتهمة ارتكاب جرائم عنف في عهد مبارك. وفي يونيو 2011؛ رجح تقرير أن المجلس العسكري أطلق سراح أكثر من 400 معتقل سياسي في الأشهر الأربعة التي تولى المنصب فيها. وبعد أن تولى مرسي الحُكم واصل الإفراج عن عشرات من السجناء، بما في ذلك العديد من الذين حُكم عليهم بالإعدام في أعمال عنف في الماضي.
ولعل من المستغربأن الجماعات السلفية الجهادية شنّت هجمات عنيفة ضد قوات الأمن المصرية حتى خلال فترة مرسي. وكانت علاقة مرسي بالسلفيين الجهاديين الثائرين في سيناء معقدة. بدأت الثورة تحت حكم المجلس العسكري عندما حاول بعض المسلحين الاستفادة من الفوضى المحيطة بسقوط مبارك في محاولة لدفع الجيش المصري للخروج من شبه جزيرة سيناء ومساعدة المسلحين في غزة. وحاول مرسي لأول مرة إثناء الجهاديين عن حملتهم من خلال مناشدة قيادات إسلامية مُشتركة والعمل من خلال وسطاء سلفيين في إقامة علاقة معهم. وعندما فشلت هذه المحادثات أصدر أوامر للجيش باتخاذ إجراءات صارمة. وفي أغسطس 2012م؛ أطلق مرسي عملية "نسر 2" لتأمين سيناء، وقام بزيادة جهود الحكومة لتدمير الأنفاق مع غزة في فبراير 2013م. ويتناقض استعداد مرسي لاستخدام القوة ضد الجهاديين مع ادعاء السيسي أن مرسي أبقى الجيش بعيدًا عن سيناء خلال رئاسته بأكملها، ولكن في الواقع نصح السيسي مرسي في عام 2012 بتجنب حملة أمنية في سيناء على أساس أنها ستثير مزيد من العنف ضد الحكومة.
ومنذ الإطاحة بمرسي؛ زادت هجمات الجهاديين ضد قوات الأمن المصرية كمًّا وكيفًا وانتشرت خارج مناطق سيناء. وعلى مايبدو أن العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في يوليو 2013 ليس فقط إحياءًا للشكاوى التي دامت طويلاً ضد النظام في القاهرة، ولكنها أيضًا تقود إلى نقد شعبي لأن زعماء القبائل في شبه جزيرة سيناء كانوا غير فعالين ولم يتحلوا بالمباديء نظرًا لتحوّل ولائهم لمن يمسك بزمام السلطة أيًا كان، وفشلوا في استخلاص منافع ملموسة لمجتمعاتهم في مقابل الحصول على دعمهم. وزادت العمليات الأمنية المتكررة من حدّة الغضبمع إنها كانت تستهدف المتطرفين، والحق يُقال إنها كانت تطال المدنيين. ونمت المشاعر المناهضة للدولة بشكل قوي لدرجة أنه كانت هناك رغبة حادة في شمال سيناء لاستخدام أحكام الشريعة محليًا، والتي تتحايل على قوانين الدولة والسلطة القانونية الرسمية. بالإضافة إلى ذلك فقد صارت المباني الحكومية في المنطقة أصبحت عُرضة لهجمات متكررة. وبالنسبة للكثير من البدو المحليين والذين لا يميليون إلى التدين، فإن الجماعات الجهادية لا تساعد فقط في وضع إطار عام للائحة اتهام أوسع للحكومة المصرية في مصر، ولكنها أيضًا توفر وسيلة لضرب تلك الحكومة بغضب.
خاتمة
قللت الانتفاضات العربية من سلطة النخبة القديمة في مصر مؤقتًا، وسمحت للإخوان المسلمين ومناصريهم من الإسلاميين بإنشاء سلطة جديدة. واستاءت النخب التقليدية القديمة من استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على السلطة وتريد التأكد من أنه لن يحدث ذلك مرة أخرى. أخطأ الإخوان في حساب مستوى شعبيتهم وقدرتهم على الصمود في وجه عودة النظام القديم. وكان رد فعل الجهات السلفية والجهادية وغيرها في مصر على سقوط الإخوان من خلال سياسات مختلفة؛فالبعض اصطف مع حكومة السيسي، والبعض انضم للإخوان في رفضهم لحكومة السيسي، والبعض شن هجمات عنيفة ضد الدولة.
ويوجد السيسي حاليًا في السلطة، وعليه أن يفكر مليًا في مخاطر ابقاء مؤيدي مرسي خارج المنافسة السياسية. وحتى الآن يظن نظام السيسي أنه يمكنه التعامل مع الإسلاميين المعارضين السلميين بنفس الطريقة التي تعامل بها مبارك مع الإسلاميين المعارضين الذين استخدموا العنف في التسعينات عن طريق الاعتقالات الجماعية والعنف. ويمثل هذا تحولاً في تعريف الدولة للتطرف الإسلامي. وجعل أسلاف السيسي العنف محك اختبار لتحديد من كان متطرف، ومَن منهم يستحق القمع المطلق. ولكن السيسي قام بتغيير التعريف الآن وجعله يتوقف على طموحات سياسية بدلاً من التزامات أيديولوجية أو عنف. اتخاذ مثل هذا الموقف ضد جماعة مثل الإخوان المسلمين -والتي يُعرف أنها سلمية ويرى العديد من المراقبين أنها لا تنتهج العنف- يهدد بدفعها أو على الأقل فصيل منها إلى ثورة طويلة ودموية ضد الدولة. لقد حدث مثل هذا السيناريو في الجزائربعد إهدار الحكومة للمكاسب التي حققها الإسلاميون في الانتخابات البرلمانية في أوائل التسعينات. ويواجه السيسي تحديًا إضافيًا؛ حيث توجد ليبيا في المنطقة الخلفية، والتي من الممكن أن توفر ملاذًا آمنًا لأعدائه في ظل ظروفها المضطربة.
عندما نتحدث للزوار؛ فإن إدارة السيسي صنفت سياستها في محاربة الارهاب كاستمرار لسياسات أسلافه تجاه الجماعات الإسلامية. وهذا كان من الممكن أن يكون صحيحًا لو أن الإخوان كانت جماعة تستخدم العنف. ولكن مقارنة بالجماعات الإرهابية التي هاجمت مصر في التسعينات والعقد الماضي فإن الإخوان لايستخدمون العنف. وقام القادة العسكريون الذين كانوا يحكمون مصر قبل الانتفاضات العربيةبالتسامح مع المنظمات الإسلامية طالما أنها لم تستخدم العنف ضد الدولة. واليوم، من أجل إدامة مبرر الحملة على جماعة الإخوان، فإن الحكومة تعتقد مُسبقًا أن الإخوان هم المسئولون عن العنف الحاصل في مصر. على سبيل المثال؛ في يوليوقامت جماعة أنصار بيت المقدس بقتل 22 جندي من حرس الحدود بالقرب من ليبيا. وكعادته؛ ألمح الجيش المصري أن قطر كانت وراء الهجوم، وربما ذلك بسبب أن قطر تدعم الإخوان، والجيش يزعم أن الإخوان يسيطرون على السلفيين المسلحين في مصر.
ويُسمح حتى اللحظةللسياسيين السلفيين السلميين بمكان على الطاولة طالما أنهم لا يهددون سلطة الحرس القديم. وقد سمح السيسي لحزب النور بالمشاركة في السياسة لإبعاد التهم التي تقول أن النظام ضد ماهو إسلامي ولإضعاف سيطرة جماعة الإخوان على الصوت الإسلامي. وأيد النور واقعًا سياسيًا جديدًا لأنه ينتظر تأثيرًا على السياسة الإسلامية إذا كان هو الحزب الإسلامي الرسمي الوحيد المنظم. ولكن إذا لم ينجح حزب النور في الانتخابات القادمة - وهو احتمال حقيقي - فإن استراتيجية الحزب القائمة ستكون قد جاءت بنتائج عكسيًا تمامًا. وعلاوة على ذلك؛ فإنه من الصعب تخيل أن الحكومة الحالية تمرر القوانين التي وافق عليها قواعد حزب النور، لذلك فإن الحزب عليه أن يبرر استمراره في المشاركة في حكومة لا تستجيب لأجندة سياسية سلفية.
ويبدو أن المستقبل البعيد مُبهم وغير مفهوم، فقد يُسمح للمعارضة الإسلامية دخول الحياة السياسة في مصر على أن يبقى ضعيفًا. وبالعودة إلى إجراءات عهد مبارك، فإن الدولة قد تسمح للإخوان بالترشح كمستقلين في انتخابات مُزورة،وهي الخطوة التي قد تُهدئ قليلاًمن المعارضة. ويمكن للحكومة أيضاً أن تمنع الإخوان من المشاركة السياسية تمامًا، ولكن تسمح باستمرار تواجدهم طالما ظلوا بعيدين عن العنف وبعيدين عن السياسة، وهي السياسة التي خدمت أسلاف السيسي جيدًا. ولكن نظرًا للطبيعة غير المتجانسة للتيار الإسلامي ضد السيسي وانقسامات الأجيال بداخله فقد يكون هناك استجابات. وربما يرغب بعض قادة الإخوان في المصالحة، ولكن العديد من الأعضاء الشباب ليسوا على استعداد للمساومة.
وهناك تعارض أيضًا بين الإخوان وحلفائهم من السلفيين السلميين، كما تبين من الانشقاق الذي حدث في قيادة الجماعة الإسلامية حول مسألة المفاوضات مع النظام. وعلى الرغم من أن الجماعة الإسلامية وقفت مع مرسي وكانت ضد الانقلاب، إلا إنها بقيت ملتزمة بالسلمية، واستنكرت الهجمات على المسيحيين والكنائس. وفي يونيو، حثّ واحدٌ من أهم الشخصيات في الجماعة - عبود الزمر - الجماعة الإسلامية والإخوان على قبول رئاسة السيسي بحجة أن مرسي السجين لا يمكن أن يقود الأمة. كما دعاهم أيضًاإلى دعم مرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة. ورفضت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي مبادرة الزمر، على الرغم من أنها اعترفت أن الإخوان كانوا لايستمعون إلى الانتقادات الموجهة لآدائهم السياسي منذ الانقلاب.
وفي الوقت نفسه؛ فإنه من غير المرجح أن يقلل الجهاديون في مصر من أنشطتهم العنيفة. ولكنهم سيستمرون في التواصل مع الجهاديين الآخرين في جميع أنحاء المنطقة لزعزعة الاستقرار في شبه جزيرة سيناء وتهديد حكومة السيسي بمزيد من الهجمات على نطاق واسع، واستهداف رجال الشرطة وجنود الجيش بانتظام في سيناء والدلتا والقاهرة. وسيظل التحدي الأمني الحقيقي الذي تمثله هذه الجماعات تهديدًا للسلام والاستقرار المصري، عن طريق ماتقدمه من بديل أيديولوجي للشباب المصري المُحبط من الإطاحة بمرسي أو بحكم السيسي أو بسبب المشاكل والعلل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
سياسة السيسي الحالية بحرمان العديد من خصومه الإسلاميين من أي وصول إلى النظام السياسي بعد أن تم تعبئتهم سياسيًا من المرجح - بقصد أو بدون قصد– أن يدفع البعض لتنبي معارضة عنيفة. ومن غير المرجح أن يغير السيسي حساباته تجاه الإخوان في المدى القصير. ويدعم سياسته اثنان من رعاته الأكثر سخاءً - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - وكلاهما يستحث تدمير جماعة الإخوان المسلمين. وخاطرت الدولتان بمليارات الدولارات وأغضبت الإسلاميين لديها لضمان نجاح السيسي في حملته الانتخابية. ويدعم السيسي أيضًا جزء كبير من الشعب المصري والحرس القديم الذي لا يريد عودة الإخوان إلى السلطة. ويمكن للسيسي أن يغيّر استراتيجيته على المدى الطويل إذا ما استمر خصومه في زعزعة استقرار البلاد وإخافة الاستثمارات الغربية. ولكن الأموال الخليجية وحالة الطوارئ خففتا من الغضب الشعبي تجاه الرئيس، وهو ما يعني أنه لا يملك الكثير من الحوافز لتغيير المسار.
ومن غير المرجح أن تختفي قريبًا مشكلة المتشددين دينيًا الذين يدعون إلى العنف ضد الدولة المصرية ومؤيديها. ويكمن الحل في فرز الجذور الدينية والسياسية للعنف، بالإضافة إلى محاولة فهم تلك الجذور لتتم معالجتها من خلال الإقناع والاحتواء بدلاً من عمليات القمع الغاشمة، ولن ينتهي هذا بين عشية وضحاها بل سيستغرق وقتًا طويلاً. وإذا نجحت هذه الجهود، فقد تجد الدولة المصرية فرصة لتجنب ما يثير شكاوى جديدة ويُظهر أفرادًا جدد بأيدلوجيات مختلفة. وفي المقابل؛ فإن فشل تلك الجهود يعني زرع بذور سقوط الحكومة الحالية. ومهما يبدو المستقبل السياسي لمصر، فإنها قادتها سيكونون بحاجة إلى وجود استراتيجية لمواجهة هذه المشكلة.